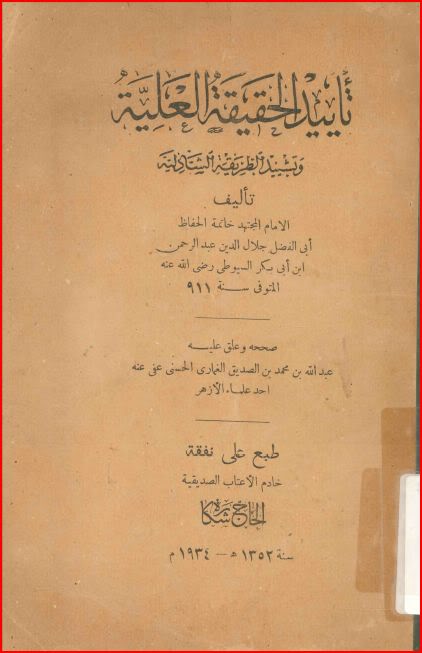[مدح القطب القسطلاني للصوفية وذمه الدخلاء فيهم]
(فصل) وقال الشيخ قطب الدين محمد بن أحمد بن علي القسطلاني -أحد أئمة الشافعية، وأحد أئمة الحديث، وأحد أئمة التصوف، أخذ عن السهروردي، واجتمع بالشاذلي، وترجمه الإسنوي في الطبقات, فقال: كان ممن جمع العلم والعمل والهيبة والورع والكرم, وطلب من مكة, وفوضت له مشيخة دار الحديث الكاملية بالقاهرة, إلى أن مات بها في المحرم سنة 686 ست وثمانين وستمئة - في كتاب له في التصوف سماه: (اقتداء الغافل بالعاقل) ما ملخصه: إن الله بحكمته ونعمته أقام في كل عصر من جعل له لسانًا معبرًا عن عوارف المعارف, مخبرًا عن لطائف العواطف, يقطع به ما اتصل من الجهل, ويخمد به ما ثار من السخف, وينير به ما أظلم من هوس النفس, ويحقق به ما اضطرب من رأي الهوى, وإنا لما دفعنا في وقتنا هذا إلى زمن طال فيه على أرباب الفضائل أرباب الرذائل, وجال فيه بالمقال على الأماثل من ليس لهم بالمماثل, تعين علينا أن نفصح لأهل الوسائل, وتبين لدينا أن نوضح ما التبس على الأفاضل ببيان الحق لمن أعرض عنه لما جهله, وتقريب الطريق عمن قصد أن يصله.
-إلى أن قال-: فلما أمر الله بالاقتفاء لأهل الاصطفاء, والإقتداء بذوي الاهتداء, ورأيت ما ظهر في زماننا هذا من اعتناء العوام بأهل الادعاء والأتباع للأهواء, لفقد نور العرفان المميز بين مراتب الأصفياء, بذلت ما في الوسع من النصح للجاهل, وأقمت ما رسمت في هذا الموضع مقام الحكم الفاصل, نوضح فيه ما التبس من حال العالم بالجاهل, والناقص بالفاضل, والحالي بالعاطل, ونفصح فيه عن بيان الفرق بين طرق الحق والباطل في سيرة من ظهر في زي القوم في الخدمة والصورة وهو عن المغني المعني بالاعتناء به بينهم زائل, وعلى المراعاة لرعونات نفسه عاكف, وفي فسح المحال في ضلالها جائل, وعن تأدبها بالآداب المرعية في طريق الأبواب المرضية حائل.
وقد دفعنا لوقت ظهر فيه اللغط, وكثر فيه الغلط واشتهر في أفعال أهله الشطط, ولا سيما من أجري عليه من الصلحاء رسم التصوف واسم الفقراء, فإن هذا اسم من أعز الأسماء, والمتصف بصفة أهله عظيم قدره عند رب السماء, لكن تلك النعوت المعهودة تبدلت بضدها, والأخلاق المحمودة منهم عادت ذميمة عند عدها, وجلهم بل أجلهم يدعى سلوك الطريق, وما مشى على حدها, فلا مصطلح القوم يعلمون, ولا بما مضى من سيرتهم يعملون, ﴿إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ﴾ [البقرة: من آية 156]. أشبهوهم بالظاهر في الصورة, وباينوهم في السيرة, في المعاني المستورة, فهم كما قال القائل:
| أمَّا الخيام فإنها كخيامهم |
* | وأرى نساء الحيّ غير نسائها |
ظنوا أن الفقر والتصوف أذكار مشهورة, ومنامات مستورة, وخيالات مذكورة, فتقيدت بهم أذهان محصورة, وأفكار مأسورة, لم تصحب فحول الرجال, ولم تشرب من ماء المعارف الزلال، زلت منها الأقدام, وتحكمت فيها الأوهام, وجعلوا التلبس بشعار الفقر مأكلة والتقدس بذكر الله بينهم مشغلة, والتآنس بالمعاشرة عن المبادرة للطاعة مكسلة. وتلك حالة لمن تأملها مشكلة, وفتنة لمن تعقلها مذهلة. ولكن طبع الله على قلوبهم فكانوا من الغافلين, وختم على سمعهم فلم يكونوا للنصيحة بالقابلين, ولا للعدول عن الضلال للهدى بالعائدين. فقد سمعت والدي أبا العباس القسطلاني يقول: سمعت الشيخ أبا عبد الله القرشي يقول لو لم ألق من المشايخ من لقيت لتوهمت أن الطريق ما عليه الناس اليوم, وما عند الناس من الطريق إلا الاسم, إلا من سلك منهم على التحقيق فإذا قال هذا في عصره, فما ظنك بهذا العصر؟
هذا كله كلام القطب القسطلاني([1]).
ثم قال: اعلم أن الله أقام هذا الدين, وأيَّد هذه الشريعة المطهرة بطائفتين: علماء الظاهر, وعلماء الباطن. ولما شاهدنا في هذه الطائفة الخلل في عصرنا حدانا ذلك على النصح والتفقه لمن يرغب في الاهتداء ببيان رتبة الداعين, وما يقصده من يعد لجناب الله من جملة الساعين.
أما رتبة الداعي فإنها من أعلى الرتب, وهي رتبة الأنبياء والأولياء والحكماء, كما قال الله تعالى: ﴿ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ﴾ [النحل: من آية 125] فسعت هذه الطائفة إلى الدعاء إلى الله, ورأت أن ذلك من باب تكثير الخير في الوجود. وتوقفت طائفة عن ذلك لاشتغالها في حق نفسها بما هو الأولى من التوجه لها.
والأولى أن يقال: إن كانت الهمة قد اشتغلت بالله حتى أقيمت داعية له بغير معاناة أسباب من خارج فإنه يتعين الإجابة. وإن كانت الهمة على الدعاء غافلة, فإنها محجوبة جاهلة, ولحظوظها من طلب الظهور واصلة.
وقد حصل الجهل في زماننا هذا برتبة الداعي, والنظر في ذلك من الأمر المهم في الدين, لكيلا يلتبس طريق المحقين بطريق المبطلين.
فإذا للتمييز بين الدعاة فائدة عظيمة في هذا الشأن, فالدعاة أربعة: (داع بالله إلى الله, وداعٍ بالله إلى سنة الله, وداعٍ بالله إلى حكمة الله, وداع إلى حظوظ نفسه بطريق الله).
(فالداعي إلى الله) هو المقرب الملحوظ, المفارق للحظوظ, يدعو إلى الصدق في العمل, والإخلاص, ويهدي من ضل إلى طريق المعرفة بالله, والاختصاص.
(والداعي إلى سنة الله), وهي العلم بالأحكام من الحلال والحرام مبصر للسالكين بطريق المهتدين السابقين.
(والداعي إلى حكمة الله) هو الداعي إلى العلم بأحكام الظاهر والباطن من علم الشريعة والحقيقة, ببيان علم الخواطر وعللها, وصفات النفوس وآفاتها, وطرق البحث عن دسائسها.
(فالداعي إلى الله) أقلهم تابعًا لمشقة ما دعا إليه، و(الداعي إلى سنة الله) تابعه كثير لممازجة النفس فيما تأتي به من الأفعال, وطلب الأعواض على الأعمال.
(والداعي إلى حكمة الله) أقل تابعًا منه لعزة الوصول إلى ما يدعو إليه من طهارة النفس وتزكيتها.
(وأما الرابع), وهو (الداعي لحظوظ نفسه بطريق ربه) فباطنه معلول بالآفات, وسره مشحون بالجهالات. إلى أن قال: ثم الدعاة على وجوه:
أحدها: داع إلى الغنى بالله من حيث اعتناؤه بالإيجاد له ابتداء, كما قال تعالى: ﴿وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا﴾ [مريم: من آية 9]، وثانيها: داع بالفقر إلى الله, فإن ذلك وظيفة العبودية.
وثالثها: داع بالأخلاق الرحيمة, كما قيل: تخلقوا بأخلاق الله. أي من الرحمة والحلم والجود والعفو, ونحو ذلك. وهذه هي أجل الدعوات.
ثم قال: وإن طريق القوم لما اندرس رَسْمه وبقي اسمه ذهبت عصابته وصاروا آحادًا في البلاد, وأفرادًا في الجد والاجتهاد, فهم خاصة الله من خلقه, وخلاصته المختارون في أرضه, لإقامة حقه، طهر أسرارهم, ونوَّر أفكارهم, فهم الداعون إلى بابه, المعروفون بعلي جنابه, الموقفون على ما أشكل من علم الطريق على أربابه.
وقد حرس الله هذه الطائفة عن امتداد يد المتلاعب بما أقام لها من الرؤساء العالمين بها, يذبون عنها طغي الطاغي وجهل الجاهل, ويميزون بين المنقطع عن الله والواصل, ويعرفون سلوك الطريق لطالبه, ويوقفون على الصواب من لم يهتد إلى مذاهبه. لا يبالون عن اعتراض جاهل أو عالم, ولا تأخذهم في الله لومة لائم.
وعلوم هذه الطائفة تشارك باقي العلوم في العقل والنقل والمفهوم, وتتميز عنها بالذوق والمنازلة, والوجد في المعاملة.
إلى أن قال: واعلم أن طائفة المتوجهين امتحنوا بثلاثة أصناف يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا؛ بمنكر لطريقهم وأحوالهم. وبمعترف بها، عالم ذلق اللسان, طلق البيان, أدخل فيها ما ليس منها, وأوهم أن ذلك العلم هو عين التحقيق المتعين فيها. وبمعترف بها جاهل بآدابها وشروطها, اتخذ أتباعًا, وقرر لهم أوضاعًا.
الصنف الأول: المنكر لعلوم هذه الطائفة, الواقف مع غرور نفسه, فهذا عدو ظاهر, واجتنابه سهل.
الصنف الثاني: العالم المعترف ظاهرًا بالطريق, المغترف بزعمه من بحر التحقيق, الذي اشتغل بعلوم الأوائل, وأوهم أنها داخلة في علوم القوم, راجحة في معتقده على علوم الشريعة. أعطي لسانًا معبرًا عن مقاصده, مترجمًا عما في ضميره, واصطلح مع نفسه وأتباعه مصطلحًا في أوضاعه, وقرر في أذهانهم أنه المشار إليه في عصره, وأن المدار عليه في طيه للعلوم ونشره, وأن الخلائق كلهم يغترفون العلوم من بحره. وهم جماعة زعموا أنهم جاسوا خلال ديار المعارف, فأفسدوا بذلك عقائد من صحبهم من الطوائف, واعتقدوا قدم الأرواح والأشباح, وامتزاج الموجودات المتماثلة والمتضادة أزلاً وأبدًا, وأن كل شيء مشكل في الصورة هو عين المتشكل الآخر, كالفيل المتشكل مع البقة.. إلى هذيان لا يقوله محصل, ولا يعتمد عليه من هو للفرق بين الحق والباطل متأمل, وأوهموا أن ذلك هو الوحدة, وأنه عين التحقيق المشار إليه وهو علم الاحاطة الذي من لم يعتقد صحته قصر فهمه وكثر وهمه, وكان محجوبًا عن العلوم الإلهية والمكاشفات الغيبية.
وهذا القول منهم دعوى لا برهان يعضدها ولا إيمان يشيدها, اغتر بها من استمع ما ألقوه إليه, ونبا عنها فهم من استقر الحق لديه, وهؤلاء هم مباينون لعلم التحقيق, محافظون على المباعدة لدقيق التوفيق, تخطوا بزخرف المقال رقاب أرباب المقامات والأحوال, واعتقدوا فيهم أنهم من الجهال الضلال, فكانوا نقمة على المستمعين وفتنة على المتوجهين.
الصنف الثالث: الجاهل بعلوم هذه العصابة, الذي جعل التلبس بما هو شعارهم وسيلة إلى أغراضه وبلوغ مرامه, فمن لم يشتغل بعلوم النفوس وآفاتها ومصادرها ومواردها في صفاتها, ويعمل على تزكية نفسه وطهارتها, فانه يعد لمعرفة علم السلوك من الجاهلين, ولا يكون لهذه الطريقة من الوارثين.
فهؤلاء الأصناف المذكورون فتنة على العوام والخواص, ومحنة يبعد منها, ولا سيما في هذا الوقت الخاص.
فإذا تبين وصف هؤلاء للعاقل تعين عليه أن يعلم وصف حال الرجل الكامل, وهو الشخص الذي فوتح قلبه بإقبال الإنابة, فدخل من باب التوبة إلى الإجابة, ثم جاهد نفسه في خلوته وعزلته بالانفراد, ثم صاحب التقوى والورع والزهد في سيره, ثم ترقى إلى المقامات والأحوال, ثم إلى مقام المعرفة, ثم عمل على ترك مراداته واجتناب الملاحظة لحظوظه, فصار عبدًا حقًا آثر الله على ما سواه في سره ونجواه, ولم يعتمد في أمره شيئًا من هواه.
وهذا الصنف هو الذي رحل في الطريق بالأدب, فأمن في الفريق من العطب, ولم يتوثب إلى طلب الرتب, فان هذه الطائفة لم تأخذ في هذا المنهج عن جهالة, بل عن علم ودلالة, وقد تقدم لها مشايخ فحول وأئمة جمعوا بين علمي الظاهر والباطن من الفروع والأصول.
إلى أن قال: وحاصل هذا الطريق يرجع إلى فقد ووجد, وجْد بالله وفقد لما سواه.
ثم قال: والعجب ممن هو جاهل, ربى نفسه, وصحب من هو مثله, ولم يتأدب بآداب الظاهر, الذي هو الشرع, ولا بآداب الباطن, الذي هو مراقبة الخواطر, كيف يتخيل في ذهنه أن يكون داعيًا إلى الله, مؤدبًا لعباد الله؟
وقد تقدم قبلنا من مشايخ الطريق الكلام على من تعاطى في سيره غير سيرتهم, وتقاضى بأفعاله ما يعد به خارجًا عن طريقتهم.
وقال أبو بكر محمد بن عبد العزيز المروزي: سمعت الواسطي -هو أبو بكر محمد بن موسى- يقول: جعلوا سوء أدبهم أخلاقا, وشره نفوسهم انبساطا, ودناءة الهمم جلادة, فعموا عن الطريق, وسلكوا فيه المضيق.
وقال أبو بكر الطمستاني: الطريق واضح, والكتاب والسنة بين أظهرنا, وفضل الصحابة معلوم بسبقهم إلى الهجرة, وبصحبتهم, فمن صحب منا الكتاب والسنة وتغرب عن نفسه والخلق, وهاجر بقلبه إلى الله, فهو الصادق المصيب.
وقال أبو العباس الدينوري: نقضوا أركان التصوف, وهدموا سبلها, وغيروا معانيها بأسماء أحدثوها, سموا الطمع إخلاصًا, والخروج عن الحق شطحًا, والتلذذ بالمذموم صولة, والبخل جلادة, والسؤال عملاً, وبذاءة اللسان ملامة, وما كان هذا طريق القوم. ولو تتبعنا أقوال المشايخ في ذلك أطلنا.
ثم قال: وقد ألف مشايخ من هذه الطائفة كتبا ذكروا فيها الأسانيد, كأبي نصر عبد الله بن علي السراج في كتاب (اللمع), وأبي عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي في كتاب (مقامات الأولياء), وأبي القاسم القشيري في كتاب (الرسالة), وأبي بكر محمد بن علي الغازي المطوعي في كتاب (المقالات), وغيرهم.
وإنما فعلوا ذلك إرغامًا لأنف منكر تعاطي رد مقالهم, وردًا على مدعي أن هذا العلم لم يرد به الكتاب والسنة فقصدوا أنهم قد اشتغلوا به كما اشتغل به أهل الظاهر من علم الإسناد, وأنهم فاتوهم بما لم يصل إليه فهمهم من علم أهل القرب والوداد.
ثم قال: واعلم أن العلم منه المحمود والمذموم, فالمحمود ما أدى إلى طهارة النفس وتزكيتها, قال تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا﴾ [الشمس: 9-10]، والمذموم ما دعاها إلى الكبر والعجب وحب الشرف والرفعة والحسد وغير ذلك.
والعلوم المأمور بطلبها قسمان: علم بالله, وعلم بأحكام الله, فالأول: العلم بأسمائه تعالى وصفاته وأفعاله, وما يجب ويجوز ويستحيل في حقه.
والثاني قسمان: علم بأحكام الدنيا المتعلقة بأحكام المكلفين وعلم بأحكام الآخرة في المنعمين والمعذبين, ثم أحكام المكلفين على ضربين: ظاهر وباطن, أما الظاهر فعلم أحكام الأمر والنهي, وهو علم الفقه, وأما الباطن فعلم الخواطر, وتمييز الصحيح منها من الفاسد، والممدوح من المذموم.
إلى أن قال: ومدار علم الباطن على الخشية, فعلى عظم الخشية في الصدر وتمكينها من القلب تتكثر المعارف فيه, وتنزل السكينة عليه.
وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ [فاطر: من آية 28]. وعلى قدر تمكن الخشية من القلب يكون العلم بالله سبحانه وتعالى, كما قال -صلى الله عليه وسلم-: «والله إني لأعرفكم بالله وأشدكم خوفًا منه»([2]).
ولا تكون الخشية إلا للعالم بالله, فالخشية باعثة على الجد في العمل, قاطعة لما اتصل من الأمل, زائدة فيما تحصل في القلب من الوجل, وقال سهل: الدنيا كلها جهل إلا ما كان منها علمًا, والعلم كله حجة, إلا ما كان منه عملاً، والعمل كله موقوف إلا ما كان منه إخلاصًا, والإخلاص كله مردود إلا ما كان منه بالسنة.
فإذا عَلِم شرف عِلْم الباطن فإنه يدور على أصلين: علم بالله وتصرفاته في مصنوعاته وأحكامه لما أتقن من مخترعاته وعلم بالنفوس ومراتبها, وتمامها ونقصها, محاسنها ومعايبها, ولأجل هذا قال تعالى: ﴿وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ [الذاريات:21].
وأحكام النفوس منحصرة في وصفين. الأول: إزالة النقص, مثل مجانبة الحسد والكبر والغصب والغل, والغش والطمع والحقد والعجز والبخل والشح والرياء والخداع والحرص والمكر والقحة, والخيانة والقسوة والغلظة والغفلة والعجلة والحدة والفخر والخيلاء والمباهاة والمنافسة واحتقار الخلق وسوء الأدب وسوء الخُلُق وحب الثناء والرغبة في الشكر والتصنع للخلق واتباع الهوى والتجبر وطول الأمل والشر والبطر والبغي والظلم والعناد والغيبة والنميمة وطلب المغالبة بالباطل وذكر معايب الخلق وخلو القلب من الحزن. والفرح بالعاجل والحزن على الغائب والاعتراض على تدبير الله, وما ضاهى ذلك من الخصال الذميمة والأفعال القبيحة.
فحق على كل مسلم أن يتفقد نفسه منها وينزهها عنها فإنها داعية إلى الهلكات, ومنها ينشأ رد الأعمال الصالحات.
الثاني: تحصيل الكمال, كمجاهدة النفس والتقوى والورع والزهد والشكر والصبر والقناعة والرضا واليقين والتوكل والتفويض والتسليم والإحسان والصدق والإخلاص والنية ورؤية المنة لله، والاحتساب في الأعمال، والسخاء والشفقة وسلامة الصدر, والمبادرة للأمر, والخشوع والتواضع والمراقبة والمحاسبة وحسن الظن بالله وحسن الطاعة وحسن الخلق وحسن المعاشرة للخلق, وحسن المعرفة بالله, وغير ذلك من صفات الكمال, فإذا نفى المذموم وأثبت المحمود من هذه الصفات ترقى عنها إلى التوبة عن الزلات ثم إلى المحاسبة لنفسه على الهفوات, ثم إلى المراقبة إلى ما يصدر منه من الخطرات, ثم إلى الفكرة فيما يتعلق بالله من صفات الفعل وصفات الذات, ثم إلى التخلق بالصفات, فيتخلق من الرحمة باسمه الرحيم, ومن الإحسان باسمه المحسن, ومن نفع العباد باسمه النافع, ومن المضرة لمن يستحق الضر من الكفار, بالقتل والسبي والأسر, ومن المسلمين العصاة بإقامة الحدود ونحوها باسمه الضار, وكذلك باقي الأسماء يتخلق بكل اسم منها فيما هو به لائق.
فإذا حصل منها التخلق المذكور ترقى إلى الاعتبار بتأثيرها في الموجودات, ووجود سراية أسرارها في المصنوعات, ثم ترقى عن ذلك إلى الاعتبار في نعمة الإيجاد, وسبق الخذلان والعنايات, ثم ترقى عن ذلك إلى الفناء في شهود الذات الصادر عنها أنواع المبدعات. ثم ترقى عن رؤية الإرادات وفتنة المرادات, ثم القى نفسه بين يدي مدبرها كأنه بعض الجمادات, فهنالك تنتهي غاية الرغبات, وتتوقف مفكرة عن منازعات الطلبات.
وقد أوضح معنى ما ذكرناه من تقدمنا من السادات, قال سهل بن عبد الله: أول ما يؤمر به المريد التبري من الحركات المذمومة, ثم التنقل إلى الحركات المحمودة, ثم التفرد لأمر الله, ثم التوقف, ثم الرشاد, ثم الفناء ثم البيان ثم الثناء ثم القرب ثم المناجاة ثم المصافاة ثم الموالاة. ولا يستقر هذا بقلبه حتى يرجع إلى إيمانه, فيكون العلم والقدرة زاده, والرضى والتسليم مراده, والتفويض والتوكل حاله, ثم يمن الله بعد هذا بالمعرفة, فيكون مقامه عند الله مقام المتبرئين من الحول والقوة, وهذا مقام حملة العرش. وليس بعده مقام.
وقال يحيى بن معاذ: قناطر العالمين سبع: أولها التوبة ثم الزهد ثم الخوف ثم الشوق ثم الرضى ثم المحبة ثم المعرفة. بالتوبة تطهروا من الذنوب, وبالزهد زايلوا الدنيا, وبالخوف جاوزوا قناطر النار, وبالشوق دخلوا الجنة, وبالرضى لبسوا قراطق([3]) العبودية, وبالحب وجدوا طعم النعيم, وبالمعرفة وصلوا إلى ما طلبوا من الدنيا والآخرة.
فإذا اعتمد ما ذكرناه من الحالات فقد انطوى له في ذلك علم الأحوال والمقامات. ثم التوصل إلى هذه الحالات تارة يكون عن جذب رباني بأن يقذف الله في قلبه ذلك بغير موقف ولا معرف, وتارة عن سلوك عرفاني, فيكون عن مبصر بحكم الطريق, مخبر عن علم الفريق.
إلى أن قال: فمن كانت لله به عناية ألهمه التفقد لخواطره فيتقي المكروه ويثبت المحمود, فيكون بذلك لربه مطيعًا, ومن أهمل نفسه وغفل عنها واتبع هواجسها وعمل على مقاصدها هلك مع الهالكين.
والعجب بالآراء والعلوم والأعمال أعظم آفة ترد على ذوي المراتب.
([1]) يرحم الله القطب القسطلاني كيف لو أدرك متصوفة وقتنا هذا الذين خرَّبوا الدين باسم التصوف، نعم لا تزال بقية باقية من أولئك المتمسكين بالتصوف الحقيقي للحديث المتواتر: «لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ». فإن الصحيح كما قال النووي وغيره: أن الطائفة عامة في جميع الأصناف من علماء عاملين وغزاة مجاهدين وغيرهم، ولكن ما أعزّ تلك البقية.
([2]) في صحيح البخاري عن عائشة قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا أَمَرَهُمْ أَمَرَهُمْ مِنَ الأَعْمَالِ بِمَا يُطِيقُونَ، قَالُوا: إِنَّا لَسْنَا كَهَيْئَتِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. فَيَغْضَبُ حَتَّى يُعْرَفَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: «إِنَّ أَتْقَاكُمْ وَأَعْلَمَكُمْ بِاللَّهِ أَنَا».
عن عائشة أيضًا قَالَتْ: صَنَعَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- شَيْئًا فَرَخَّصَ فِيهِ، فَتَنَزَّهَ عَنْهُ أَقْوَامٌ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- فَخَطَبَ فَحَمِدَ اللَّهَ ثُمَّ قَالَ: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَتَنَزَّهُونَ عَنِ الشَّيْءِ أَصْنَعُهُ، فَوَاللَّهِ إِنِّي لأَعْلَمُهُمْ بِاللَّهِ وَأَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً».
 الرئيسة
الرئيسة