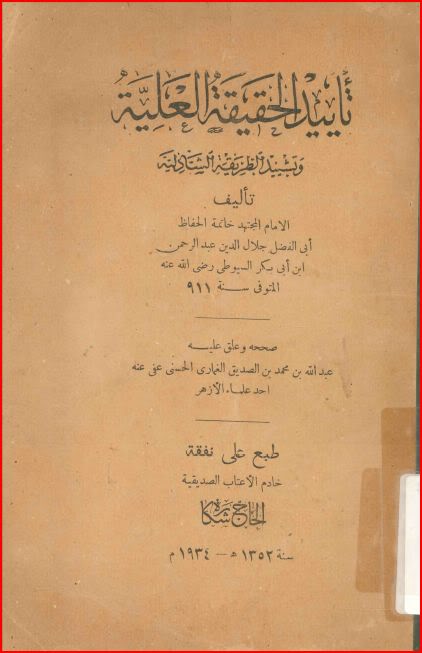[الرد علىٰ الباحثين من المتصوفة]
(الأمر الأول) تذنيب: تقدم ذكر متخلق بالصفات, فربما ظن أن المتخلق اتصف بصفات الله حقيقة, وهذا محال, إنما أخذ الاسم فقط لا المعنى الذي وُصِفَ به الباري, بل بمعنى حادث يليق بالعبد, كما تقدم تقريره في كلام القسطلاني.
فالرحيم -مثلا- تطلق على الله وعلى غيره, لكن معناه في حق العبد رقة القلب, وهو محال على الله, فالرحمة في حقه سبحانه إرادة إيصال الخير أو فعله, على الخلاف في كونها صفة ذات أو صفة فعل.
قال الغزالي في (الإحياء): الأسامي كلها إذا أطلقت على الله وعلى غير الله لم تطلق عليهما بمعنى واحد أصلاً، حتى أن اسم الموجود الذي هو أعظم الأسماء اشتراكا لا يشمل الخالق والخلق بوجه واحد, بل كل ما سوى الله فوجوده تابع لوجوده, والوجود التابع لا يكون مساويًا لوجود المتبوع, إنما الاستواء في إطلاق الاسم. نظيره اشتراك الفرس والشجر في اسم الجنس وليسا متشابهين في الجنسية.
وهذا التباعد في سائر الأسامي أظهر, كالعلم والإرادة والقدرة وغيرها, فكل ذلك لا يشبه فيه الخالق الخلق. انتهى.
وها هنا انتهى الكلام في (الأمر الأول), وهو التنزيه عن الحلول والاتحاد. وقد أطلنا فيه, وحق لنا أن نطيل, فإنه مزلة أقدام.
(الأمر الثاني) القول بالإباحة: وهذا أيضًا لم يقل به أحد من المعتبرين, وإنما قال به بعض الغلاة, زعموا أن الإنسان إذا وصل إلى حد الفناء سقط عنه التكليف, وأبيحت له المحرمات. وقد تقدم في كلام القسطلاني الإشارة إلى ذم ذلك, وأنه زندقة, وكذا في كلام أبي نعيم.
قال القاضي عياض ما معناه الإجماع على تكفير من قال بتعطيل الأوامر والنواهي من المتصوفة وأصحاب الإباحة.
وقال القونوي في شرح التعرف: يحكى عن طائفة من أهل الزيغ والضلال أن العبد إذا وصل إلى الله سقطت عنه التكاليف. وعللوا ذلك بأن المقصود من التكليف هو القرب والوصول إلى الله, فإذا حصل المقصود فلا حاجة إلى الوسيلة. وهذا محض الكفر والإلحاد في دين الله, فإن من المعلوم بالضرورة أن أقرب الناس إلى الله أنبياؤه ورسله. ولم يرتفع عنهم التكليف إجماعًا, فمن دونهم أولى.
قال: وذكر الغزالي أنه إن وقع في كلام أحد من المعتبرين ما يوهم ذلك فتأويله أنه يسقط عنه كلفة التكليف لا نفس التكليف ومعنى ذلك أنه يتلذذ بالعبادات فلا يجد لها كلفة في الصلاة وقوله: «أرحنا بها يا بلال»([1]) ونحو ذلك. انتهى.
والدليل على أن طريق الجنيد والشاذلي بريئة من ذلك ما ذكر في ترجمة الجنيد أنه حضر وقت موته وهو يصلي, فكان قاعدًا يصلي ويثني رجليه كلما أراد أن يسجد, فلم يزل كذلك حتى خرجت الروح من رجله, فصلى وهي ممدودة, فقيل له: لو اضطجعت. فقال: هذا وقت يؤخذ منه, ولم يزل ذلك حاله حتى مات.
وقال أبو عبد الرحمن السلمي: سمعت جدي يقول: دخل أبو العباس بن عطاء على الجنيد وهو في النزع فسلم عليه فلم يرد عليه, ثم رد عليه بعد ساعة, فقال: اعذرني فإني كنت في وردي. ثم حول وجهه إلى القبلة وكبر ومات.
وقال أيضًا: سمعت عبد الواحد بن بكر قال: سمعت محمد بن عبد العزيز يقول: سئل الجنيد عمن لم يبق عليه من الدنيا إلا مقدار مص نواة. فقال: المكاتب عبد ما بقي عليهم درهم.
وقال الشيخ([2]) في دعائه لما قال: وأعطنا كذا وكذا والرزق الهني الذي لا حجاب به في الدنيا, ولا عقاب عليه في الآخرة, على بساط التوحيد والشرع.
قال الشيخ تاج الدين في (التنوير) قوله: (على بساط علم التوحيد) أي على أن أشهدك فيما رزقتني, وأراك فيما أطعمتني, فلا أشهد ذلك من غيرك, ولا أضيفه إلى أحد من خلقك. وكذا أهل الله لا يأكلون إلا على مائدة الله, أطعمهم من أطعمهم, لعلمهم أن غير الله لا يملك معه شيئًا, فسقط بذلك شهود الخلق عن قلوبهم, فلم يصرفوا لغير الله حبهم, ولا وجهوا لمن سواه ودهم, إذ رأوا أنه أطعمهم ومنحهم من فضله.
وقوله: (والشرع): لأن من استرسل مع إطلاق التوحيد, ورأى أن الملك لله تعالى, وأن لا ملك لغيره معه, ولم يتقيد بظواهر الشريعة فقد قذف في بحر الزندقة, وعاد حاله بالوبال عليه, ولكن الشأن أن يكون بالحقيقة مؤيدًا وبالشريعة مقيدًا, فإن الانطلاق مع الحقيقة من غير تقييد بالشريعة تعطيل.
(الأمر الثالث) القول بالوحدة المطلقة: وقد بَيَّن القسطلاني فيما تقدم نقله عنه أن هذا القول قال به بعض المتصوفة الذين اشتغلوا بعلوم الأوائل وأدخلوها في فنهم. ومن مذهب الفلاسفة القول بقِدَم العالم وقدم الأرواح وإثبات الهيولى, وكل ذلك تغيّر خارج عن ملة الإسلام, نعوذ بالله منه, وعليه تتفرع الوحدة المطلقة.
وممن ركب له تصوفًا على مذهب الفلاسفة ابن سينا ذاك الأعمى القلب والبصيرة.
فجزى الله أئمتنا خيرًا الذين حرَّموا الاشتغال بعلم المنطق والفلسفة حذرًا من أن يجر إلى شيء من عقائدهم الفاسدة, كما قال ابن الصلاح في تعليل ذلك: مدخل الشر شر.
والعجب ممن أراد الوصول إلى مرتبة الصالحين وترك سنة سيد الأنبياء, والصالحين رسول الله -صلى الله عليه وسلم-, وعمد إلى سنة قوم كفار ضُلال, وبنى قواعده عليها ليصل, نعم وصل, ولكن إلى شفا جرف هار.
وقد حدثت عن العلامة الكريمي أنه حكى أن بعضهم رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- في النوم, فسأله عن الغزالي والفخر الرازي وابن سينا. فأثنى على الغزالي خيرًا كثيرًا, وقال في الفخر: إنه معاتب. وقال في ابن سينا: إنه أراد أن يصل إلى الله بغير واسطتي فانقطع.
وإذا تأملت كتب المعتبرين, كرسالة القشيري, وغيرها وكلام الشاذلي, وكتب الشيخ تاج الدين, لم تجد فيها لفظة من ذلك. وإن وقع في كلامهم لفظ الوحدة فمرادهم به التوحيد وانفراد الله بالوجود ولوازم الوجود, لا ذلك الذي يريده أولئك.
(الأمر الرابع) الاعتماد على كل خاطر, سواء وافق الشرع أم خالفه, وربما كان صاحب هذا الخاطر ممن لم يتقدم له نظر في الشرعيات أصلاً, لا أصولاً ولا فروعًا, وربما انضم إليه أنه لم تحصل له الرياضة التي يشرطها أهل القول بالإلهام, فلا حصل هذا ولا هذا, ثم أخذ يعتمد على جميع وساوسه وخواطره ويقررها ويدونها ويعمل عليها, ويدعي أنها التحقيق, ويَرُدّ بها القواعد الشرعية والأحاديث النبوية, ويزعم أن الفقهاء بعيدون عن هذا الذوق, فليت شعري أجاءه من الله جبريل فأخبره أن خاطره معصوم, وأن الفقهاء كلهم حجبوا عن هذا الأمر وإدراك أنه حق؟
بل هذا خرق لإجماع كل طائفة حتى الصوفية, فإنهم نصوا على أن الخواطر غير معصومة, وأنها لا بد من عرضها على الكتاب والسنة, وأن لا بد من تقدم الاشتغال بهما.
قال أبو سليمان الداراني: ربما تقع في قلبي النكتة من نكت القوم أيامًا, فلا أقبلها إلا بشاهدين عدلين من الكتاب والسنة.
وقال أبو حفص الحداد: من لم يزن أفعاله وأحواله في كل وقت بالكتاب والسنة ولم يتهم خواطره فلا تعده في ديوان الرجال.
وقال الجنيد: الطريق مسدود على الخلق إلا على من اقتفى آثار رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. وقال: من لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الأمر, لأن علمنا هذا مقيَّد بالكتاب والسنة. وقال: مذهبنا هذا مشيد بحديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
وقال الغزالي في (الإحياء) في باب العزلة: المحتاج إلى التعلم لما هو فرض عليه عاص بالعزلة, وإن تعلم الفرض وكان لا يتأتى منه الخوض في العلوم وراء الاشتغال بالعبادة فليعتزل. وإن كان يقدر على التبرز في علوم الشرع والعقل فالعزلة في حقه قبل التعلم غاية الخسران, ولهذا قال النخعي وغيره: تفقه ثم اعتزل. ومن اعتزل قبل التعلم فهو الأكثر مضيع أوقاته بنوم أو فكر هوس, وغايته أن يستغرق الأوقات بأوراد يستوعبها فلا ينفك عن أنواع من الغرور تخيب سعيه, وتبطل عمله, من حيث لا يدري, ولا ينفك في اعتقاده في الله وصفاته عن أوهام يتوهمها, وعن خواطر فاسدة تعتريه فيها, فيكون في أكثر أحواله ضحكة للشيطان وهو يرى نفسه في العُبَّاد. فالعلم هو أصل الدين, فلا خير في عزلة العوام والجهال.
وقال في باب الإلهام: زعم قوم من أهل التصوف أن الطريق في حصول الإلهامات أولا قطع علائق الدنيا بالكلية, فيفرغ قلبه عنها, ويقطع همه عن الأهل والمال والولد, وعن العمل والولاية والجاه, ويصير قلبه إلى حالة يستوي فيها وجود كل ذلك وعدمه, ثم يخلو بنفسه في زاوية مع الاقتصار على الفرائض والرواتب, ويجلس فارغ الهم مجموع القلب, ولا يفرق فكره لقراءة قرآن, ولا يتأمل في تفسيره, ولا يكتب حديثا ولا غيره, بل يجتهد أن لا يخطر بباله شيء غير ذكر الله تعالى, ويلزم في الخلوة قول: الله. الله. الله. على الدوام, مع حضور القلب, إلى أن ينتهي إلى حالة يترك تحريك اللسان, ويرى كأن الكلمة جارية على اللسان, ثم يصير على ذلك إلى أن ينمحي أثرها عن اللسان, فيصادف قلبه مواظبا على الذكر, ثم يواظب إلى أن ينمحي من القلب صورة اللفظ وحروفه وهيئة الكلمة, ويبقى معنى الكلمة مجردًا في قلبه, حاضرًا فيه, كأنه لازم لا يفارقه.
وله اختيار في استدامته في هذه الحالة بدفع الوسواس وليس له اختيار في استجلاب رحمة الله, بل هو بما قد فعله قد تعرض لنفحات الرحمة, فلا يبقى إلا الانتظار لما يفتح الله من رحمته, فعند ذلك إذا صدقت إرادته, وصَفَت همته, وحسنت مواظبته, ولم تجاذبه شهواته, ولم يشغله حديث النفس بعلائق الدنيا, تلمع لوامع الحق في قلبه, ويكون في ابتدائه كالبرق الخاطف لا يثبت ثم يعود, وقد يتأخر, وإن عاد فقد يثبت, وقد يكون مختلفا, وإن ثبت فقد يطول ثباته, وقد لا يطول, وقد يتظاهر مثاله على التلاحق, وقد يقتصر على فن واحد. ومنازل أولياء الله فيه لا تحصى, كما لا يحصى تفاوتهم. وقد رجع هذا الطريق إلى تطهير محض من جانبك, وتصفية وجلاء ثم استعداد أو انتظار فقط.
وأما النظار وذوو الاعتبار فلم ينكروا وجود هذا الطريق وإمكانه وإفضاءه إلى المقصود على الندور, ولكن استوعروه واستبطؤوا ثمرته, واستبعدوا اجتماع شروطه, وقالوا: إن محو العلائق إلى ذلك كالمعتذر, فإن حصل في حالة فثباته أبعد منه, إذا بدأ وسواس وخاطر يشوش القلب, قال رسول -صلى الله عليه وسلم-: «قلب المؤمن أشدّ تقلبا من القِدْر إذا استجمعت غليانا»([3]).
وقال -صلى الله عليه وسلم-: «قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن»([4]). وفي أثناء هذه المجاهدة قد يفسد المزاج ويختلط العقل ويمرض البدن, وإذا لم تتقدم رياضة النفس وتهذيبها بحقائق العلوم نشبت بالقلب خيالات فاسدة تطمئن النفس إليها مدة طويلة إلى أن تزول, والعمر ينقضي دون النجاح فيها. فكم من صوفي سلك هذه الطريق ثم بقي في خيال واحد عشرين سنة, ولو كان هذا قد أتقن العلم من قبل لانفتح له وجه التباس ذلك الخيال في الحال, فالاشتغال بطريق التعلم أوثق وأقرب إلى الغرض.
وقالوا إن ذلك يضاهي ما لو ترك الإنسان تعلم الفقه وزعم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يتعلم ولكن صار فقيهًا بالوحي والإلهام, عن تكرار وتعليق, وزعم أنه ربما انتهى بالرياضة إلى ذلك.
ومن ظن ذلك ظلم نفسه وضيَّع عمره, بل هو كمن ترك طريق الكسب والحرافة رجاء العثور على كنز من الكنوز, فإن ذلك ممكن, ولكن بعيد جدًا, فكذلك هذا. وقالوا: لا بد أولا من تحصيل ما حصله العلماء, فعساه ينكشف بالمجاهدة بعد ذلك. انتهى كلام الغزالي.
وقال القطب القسطلاني: في علوم هذه الطائفة مواجيد تَرِد عليهم من سوابق أعمال حصلت لديهم, وأحوال ورثوها عن أعمال صححوها, فلا يرث الأعمال إلا من صحح الأحوال. وأول ذلك علوم الشريعة المتعين عليها, من علم الفقه وأصول الدين, على طريق الكتاب والسنة والسلف الصالح دون التعمق في البحث عن دقيق الشبه وغوامضها, فإذا حصل من ذلك ما فيه كفاية استعمل ما علم, وجد في الخدمة ما استطاع، فأول ما يلزمه البحث عن آفات النفس وعِلَلها ومعرفة دَخَلِهَا وخللها وتهذيب أخلاقها والتوسل إلى سد طرق أبواب فتنة الدنيا ومكايد الشيطان, والاجتهاد والاحتراز منها, وهو جُل علم الحكمة الذي قال الله تعالى فيه: ﴿وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ [البقرة: من آية 269].
فإذا تمرنت النفس على هذه الحالات والوظائف, ولانت أخلاقها وطباعها عن القسوة والفظاظة, وتطهر ظاهرها, وصَفَا باطنها, تمكن السالك حينئذ من مراقبة خواطره وتصفية أسراره, وهو المعبر عنه بعلم المعرفة, ولسان العبارة يفصح عنه.
ثم بعده علم الخواطر والمكاشفات والمشاهدات, وهو الموصوف بعلم الإشارة. وهذا العلم من خصائص الصوفية بعد مشاركتها في العلوم المشهورة المذكورة, وإنما قيل له علم الإشارة لأنه يقصر عنه لسان العبارة, لأنه علم ذوق ومنازلة, ومواجيد متواصلة, ولا ينحصر ذلك في عبارة لقائل, إنما يجري على اللسان ما هو نفع وتعليم لقائل, فقد روي مرسلا([5]) من حديث سعيد بن المسيب قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إن من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه إلا أهل المعرفة, فإذا نطقوا به لم ينكره إلا أهل الغرة بالله». وروي مسندًا من حديث عطاء عن أبي هريرة([6]) -رضي الله عنه-.
وقال في موضع آخر: لا غنى بالمتوجه عن العلم, فإن لم يتسع وقته له سأل عن أمر دينه, ولا يستبد بما يخطر له في ذلك, فإنه يخرج به عن طريق الاستقامة. انتهى.
وقال الشيخ أبو الحسن الشاذلي -رضي الله عنه-: إذا كنت في درجة الخواص من القاصدين, وعرض لك في عزلتك الوسواس بما يشبه العلم من طريق الإلهام والكشف, من حيث التوهم فلا تقبل, وارجع الحق المقطوع من كتاب وسنة.
واعلم أن الذي عارضك لو كان حقًا في نفسه وأعرضت عنه إلى الحق بكتابه وسنة رسوله لَمَا كان عليك عتب في ذلك, لأنك تقول: إن الله قد ضمن لي العصمة في جانب الكتاب والسنة ولم يضمنها لي في جانب الكشف والإلهام والمشاهدة, فكيف لو قبلت ذلك من طريق الإلهام لم تقبله إلا بالعرض على الكتاب والسنة, فإذا لم تقبله إلا بهما فما بالك تأنس بالوساوس المتوهمة؟ فاحفظ هذا الباب حتى تكون على بصيرة من ربك ويتلو الشاهد ذلك, والبينة لا خطأ معها ولا إشكال. والحمد لله. انتهى.
([1]) رواه أحمد وأبوداود من حديث رجل من الصحابة لم يسم بإسناد صحيح، وقد سُمي في رواية الطبراني من طريق عيسى بن يونس عن مسعد عن عمرو بن مرة عن سلمان بن خالد أراه من خزاعة قال: وددت أني صليت فاسترحت فإني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «يا بلال أقم الصلاة وأرحنا بها».
([3]) رواه أحمد والحاكم وصححه من حديث المقداد بن الأسود بلفظ: «قلب المؤمن أشد تقلبًا من القدر في غليانها».
([4]) لفظ الحديث: «إِنَّ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ كُلَّهَا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ، كَقَلْبٍ وَاحِدٍ يُصَرِّفُهُ حَيْثُ يَشَاءُ». كذا رواه أحمد ومسلم من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-.
([6]) كذلك رواه أبو عبد الرحمن السلمي في الأربعين والديلمي في مسند الفردوس، والطبسي في الترغيب من طريق عبدالسلام بن صالح الهروي بسنده المتقدم.
 الرئيسة
الرئيسة