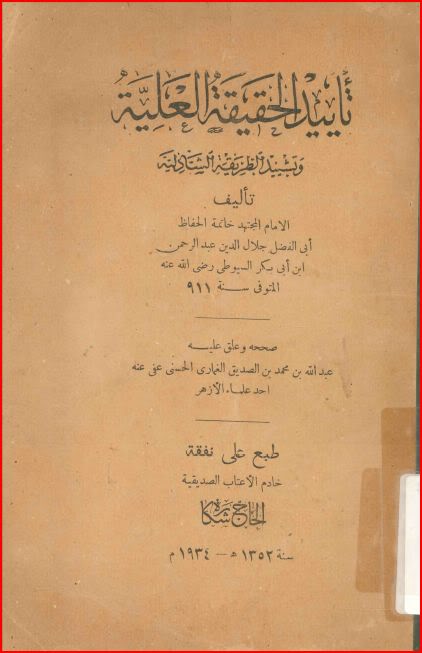[مبحث الفقير والصوفي أيهما أعلى]
قال أبو عثمان الحيري: العجب يتولد عن رؤية النفس وذكرها ورؤية الخلق وذكرهم. وقال يوسف بن الحسين: يتولد الإعجاب بالعمل من نسيان رؤية المنة فيما يجري الله لك من الطاعات.
ثم قال: واعلموا أن الناس قبلنا صنفوا فيما يلزم من يسلك هذا الطريق من الآداب, وما يتعين عليه من المراعاة لمخالفة العوائد في الوقوف مع الحظوظ والأسباب, وما يثمر له ذلك من الحسنى في دار المآب, فلو اهتدى السالكون بشيء من طرق الصواب نظروا في كتبهم, وسمعوا ما ألقوه لهم من الخطاب, لكنهم قالوا: إن نظر الفقير في الكتب وطلب العلم من أعظم الحجاب. وما ذكروه فهو كلمة حق أريد بها باطل, وصفة نقص تحلى بها من هو عن الكمال عاطل, وإنما ذكر أهل الطريق ذلك في قوم من صفتهم أنهم حصلوا ما تميزوا به عن أهل هذا الشأن من الشريعة والحقيقة, فاستغنوا عن النظر في غير ذاتهم, وفتحوا عن الغيب بما يشهد لهم بنجاتهم, فهم بالله مع الله معرضون عن ملاحظة صفاتهم. طهروا عن ملاحظة أنجاس الأغيار, وستروا عن الشهوة لما صفا وقتهم عن الأكدار, فهم كما قال بعض الألباء: طنين الذباب, وصرير الباب يشوش على ذوي الألباب. فمن كان كذلك فإنه مشغول بما هو فيه عن النظر في الكتاب.
وأما من هو عري عن علم الظاهر والباطن فحقه أن يعلم ما يحتاج إليه في الطريق التي يسلكها, فإن أبى واستكبر فإنه بعيد من الوصول إلى منهج السعادة.
ثم قال: اعلم أن العلوم المطلوبة تنقسم إلى علم وعمل, كالفقه والنحو والطب وغير ذلك. وكذلك علم هذه الطائفة ينقسم إلى علم بمصطلح أهلها, والى عمل بأخلاقها, وقد اختلف أهل الطريق في الفقر والتصوف والفقير والصوفي: فهل هما سواء أو أحدهما أتم من الآخر؟ فقال قوم: هما سواء.
وقيل: الفقر أعلى, لأن الكتاب والسنة نطقا به, واسم التصوف محدث لم يكن يعهد في السلف الصالح إطلاقه, والذي عليه أكثر أئمة هذا الشأن, ورجحه شيخنا الشهاب السهروردي أن اسم التصوف والصوفي أعلى مرتبة وأولى نسبة, وأخص بالمعنى المراد.
لأن الفقير يطلق عمومًا على من افتقر من المال, وخصوصًا على من افتقر بكليته إلى الله في جميع الأحوال, والتصوف إنما يطلق على الفقير الخاص بزيادة أوصاف أخر. وأيضًا فالفقير هو الشخص المتمسك بعروة فقره, المستشرف بطلب أعواض المثوبات على صبره وشكره, بملابسته له عند الله إلى تعظيم قدره الواقف معه على نفعه وضره, وأما الصوفي فهو الفقير الذي أسقط الوقوف مع الأعواض, وعمل على الصد عن الموجودات المنقسمة إلى الجواهر والأعراض, وقطع العلائق والعوائق, وواصل الفناء عن التطلع لغير الخالق, وباين الأكوان والأزمان قلبًا وقالبًا, وبقي بالله ملاحظًا طالبًا, وترك نفسه عن التطلع لها جانبًا, وجعل مع الخلق جميل الخلق له صاحبًا, ولم يتقيد بمقام أو حال, فيكون في صفقة بيعته خائبًا.
فإذا علم الفرق بين الفريقين تبين الحكم على الطريقين.
ثم أنه قد كثر التشبه في وقتنا بالطائفتين, وغر أرباب البصائر في التمييز بين الجهتين, فقوم حاكوا منهم الأفعال في الصور, وباينوهم في المعاني والأثر, فتجردوا ظاهرا إيهاما وتعلقوا باطنا أحكاما, فسعوا في تحصيل لذاتهم وشهواتهم وما تعبدوا بأحكام الطريق في حركاتهم وسكناتهم, وأفسدوا من تعلق بهم لإنالتهم لطلباتهم.
وقوم نطقوا باللسان الخارج عن المصطلح, وقرروا في الأذهان أن ذلك أكمل المعنى المقترح, وصنفوا على مقاصدهم كتبا كثيرة خارجة عن طريق القوم, داخلة فريق الذم لمن تعاطاها واللوم, مجانبة لعقائد الإيمان الصحيحة, مقررة لقواعد البهتان الصريحة, محررة لقواعد البرهان المنتجة, قد بنيت على قواعد تلقيت بالتقليد, فوقعت في النقص عن طلب المزيد, وأوهموا أن ذلك عين المراد بين هذه الطائفة, وإن لم يفهم ذلك المصطلح فإن أذهانهم([1]) واثقة, وعكفوا على علم الفلسفة تدوينا, وسموه بالحقيقة بالتحقيق والاحاطة وهما وتخمينا, لا علما ويقينا وعدلوا عن التصوف وما حصل لهم شيء من التعرف.
إلى أن قال: ونهاية علم التصوف هو اطراح العادات ومخالفة الإرادات, مسلما مع من له الأمر, وهو الفاني في رؤية الأشياء بالمنشئ لها, والفاني في فنائه, عن رؤية فنائه فيبقى بالله باقيا, وهو المحبوب الملحوظ والمربوب المحفوظ.
 الرئيسة
الرئيسة